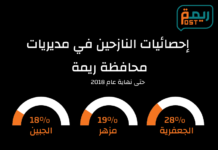ما إن يُعلن في التلفاز مساءً أن اليوم التالي هو اليوم الأول للعيد؛ حتى ترفرف روحي من شدة الفرحة التي ليس بوسعي اخفائها، وكيف يمكنني إخفاء فرحة العيد! وهي أكبر من أن تسعها قريتنا الجبلية الصغيرة، فضلاً عن قلبي الصغير الذي يتزايد نبضه كلما سمعت أخبار قدوم العيد، فأحلّق في أحلام اليقظة متخيلاً كيف سأبدو في ملابسي الجديدة؟
حفاوة الاستقبال
دون انتظار مجيء الصباح، أسارع بالطلوع إلى سطح منزلنا الواقع في أعلى قمة جبلية، أنادي أطفال قريتنا الذين يهرعون هم أيضًا لاعتلاء الأسطح، فرحًا بقدوم العيد، نتشارك السعادة والضحكات بالتساوي، ونداعب أصداء ضحكاتنا القادمة من أعماق الوديان. لم تنتهي حفلتنا بعد؛ بل يذهب كلٌ منّا لتحضير متطلبات طقس استقبال العيد المسائي المسمى “المناير” أو “التنصير” في بعض المناطق.
بروح مليئة بالشغف، تكاد من غمرة السعادة أن تطير، أذهب لآخذ مادة الرماد من موقدنا الحطب، البدائي – الحديث، فالحقيقة لم نستغني عنه بعد، فهو المنقذ الوحيد لطهو الطعام في ظل انعدام مادة الغاز. وحين لا يكفي الرماد الذي جمعته، أعود لأسرق حفنة رماد أخرى من موقد الفحم الذي تحرص جدتي على أن يظل مليئًا بالرماد ليحافظ على اشتعال الفحم الخاص بـ “المداعة” الخاص بها.
في صحن معدني مليء بالرضوض والتجاعيد، لم نعد نستخدمه في طبخ الطعام، أضع الرماد لأصب عليه مادة “الكيروسين” وأخلطهما جيدًا لأصنع مزيجًا يشبه الخلطات السحرية التي تبيعها الراهبات للآخرين ليحصلوا على السعادة، فهي كذلك بالنسبة لنا نحن الأطفال. حيث أصنع من ذلك المزيج كرات دائرية صغيرة، أرصها بالتوالي على حافة سطح المنزل – ومثلي يفعل معظم الأطفال – وأشعل النار فيها واحدة تلو الأخرى.
حين يكتمل إشعال الكرات (القناديل) الصغيرة المرصوصة على حواف سطح المنزل، يبدو المشهد مختلفًا، القناديل الضوئية التي تحيط برؤوس المنازل المتناثرة على الجبال، تبدو كأنها عمامات صنعت من خيوط القمر. فيزداد الليل بهاءً وجمالاً حين يقوم معظم الأطفال بذات الطقس الليلي. ومع جمالية المشهد تتعالى أصوات الألعاب النارية لتعبر عن فرحتنا ودفء حفاوتنا بقدوم العيد.

عفوية الفرحة
بمشاعرنا المتقدة اشتياقًا لقدوم الصباح، نشعر أن المساء قد طال، وأن ساعاته تمر ببطئ شديد يفوق قدرتنا على التحمّل. وعلى هامش الانتظار الطويل الذي نشعر به، نضع ملابسنا الجديدة بجوارنا حيث ننام، إلى جانب أحلامنا الصغيرة التي تلامس أرواحنا. أحلامنا الصغيرة التي نصنع من خيوطها ابتسامتنا صباح يوم العيد، هذا اليوم ننتظره كل عام لنعيش كل تفاصيله الجميلة ببراءة الطفولة وعفويتها.
وما إن تطل خيوط الصباح بعد مساء طويل؛ حتى نصحو والشغف والحماس يهيمن على كل تصرفاتنا، نتسابق لارتداء ملابسنا الجديدة، نسترق بعض من رشات العطر، ونذهب برفقة كبار العائلة لأداء صلاة العيد. إن الاستماع إلى تكبيرات العيد في المسجد وحده يخلق لحظات فرائحية وروحانية تبعث الاستقرار والهدوء في النفس وتسمو بالمشاعر إلى أعلى مراتب السعادة.
بينما استمع لخطبة العيد، تبقى عينيَّ تراقب كل الآتين إلى المسجد خصوصًا العائدين من المدينة، لكن ما يهمني أكثر هو مظاهر الأطفال، حيث كلُ واحد منّا يحاول التأكد من أنه يمتلك البدلة الأجمل ويبدو مظهره أفضل من البقية. ولا تكف أعيننا من تقييم ملابس بعضنا البعض بعفوية وبقلوب نقية من التمييز السلبي، فكل ما يهمنا أن نبدو أجمل في عيون من حولنا.
ما أجمل تلك العفوية التي نتصرف بها نحن أطفال القرية البسطاء، حينما نرتدي الملابس الجديدة ونتعمّد إبقاء “العلامة التجارية” معلقةً على صدورنا كي نثبت للآخرين أنها جديدة وأنيقة. وعلى مدى يومين أو ثلاثة، ورغم اتساخ الملابس نحرص على أن تبقى تلك “العلامة” معلقة، وقد يثير أمر انتزاعها أو قطعها من فوق ملابسنا خناقًا مع أقراننا، وكثيرًا ما يحدث ذلك.
تفاصيل جميلة
تثيرني لحظات العيد بكل تفاصيلها الجميلة، زيارات الأقارب، أكل الشوكلاته والزبيب وحشو ما تبقى منها في جيوبي حين يصرُّ الأقارب علينا بأخذها، شراء الطماش والألعاب النارية وإطلاقها مع بقية الأطفال أثناء زياراتنا الأسرية، شغبنا المستمر أثناء اللعب، عراكنا العفوي بسبب تدخل أحدنا بلُعبة الآخر، لينتهي الشجار غالبًا باللعب، مرةً بمرة بالتداول.
لزيارة الأقارب في العيد نكهة أخرى لا تشبه بقية الزيارات، فحين أذهب برفقة أبي لزيارة نساء عائلتنا المتزوجات في قريتنا والقرى المجاورة، نحظى بحفاوة الاستقبال وبساطة الضيافة، بالرغم من تعكّر مزاجي بعد رفض والدي منحي “عسب العيد” لأعطيه لهنَّ أنا، كي أشعر أني أصبحت رجلاً، لكنه دائمًا ما يقنعني بأنه سيقوم بهذا الواجب نيابة عني وعنه.
كم أشعر بالسعادة حين أحصل على عيدية “عسب العيد” كبيرة! فـ ألف ريال كافيةً – بالنسبة لطفل قروي لم يعتد على المصروف اليومي كأطفال المدينة – لتجعلني أشعر كما لو أني ملكت الدنيا، تلك السعادة النقية أمرًا لا يمكن وصفه أو التعبير عنه. وحدها نظرات التلصص بين لحظة وأخرى وتحسس مبلغ العيدية في جيبي، دون أن ينتبه الآخرون من حولي؛ كفيلة بوصف سعادتي.
إن العيد في قريتنا الهادئة موسم للفرحة والضحكة التي لا تفارق شفاهنا، وفرصة فرائحية لا تكرر في العام سوى مرتين، لنظل بعدها ننتظر قدومه بشوق يكبر أعمارنا بمراحل، نخطط لساعاته وأيامه، نفكر في كيفية استقباله بحفاوة في كل مرة، نتساءل سرًا هل الملابس الجديدة ستكون أجمل من ملابس العيد السابق، وما الألعاب التي سنشتريها.