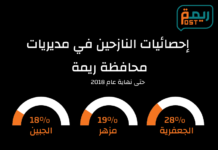في مجتمعاتٍ تنهشها الصراعات القبلية وتؤرقها قضايا الثأر، يبرز القائد ليس بمدى قوته العسكرية فحسب، بل بقدرته على حقن الدماء وإرساء السلم الاجتماعي. وفي الذكرى الخامسة لرحيل الفريق يحيى مصلح مهدي، يستذكر اليمنيون بمهابةٍ تلك الشخصية الاستثنائية التي استطاعت أن تزاوج بين صرامة القائد العسكري وحكمة المصلح الاجتماعي، محولاً مناطق النزاع إلى واحات من الاستقرار والسكينة.
لم يكن الفريق يحيى مصلح مجرد مسؤول يمر بموكب رسمي بين المدن، بل كان “غيثاً” حيثما حلّ. في محافظتي ذمار وإب، لا تزال قصص تدخله لإنهاء النزاعات المعقدة تُروى كأساطير واقعية؛ فقد كان يمتلك بصيرة نافذة تدرك أن استقرار الدولة يبدأ من استقرار المجتمع. لم يكن يلجأ إلى القوة الغاشمة لفرض الحلول، بل كان يجلس في “دواوين” القبائل، مستمعاً ومحاوراً، مستخدماً رصيده الهائل من النزاهة والصدق لإقناع الأطراف المتنازعة بأن الوطن يتسع للجميع. يقول عنه مشايخ ووجهاء عاصروا فترته: “كان يحيى مصلح يأتي إلينا لا ليمارس سلطة المحافظ، بل ليمارس دور الأخ الأكبر، كانت كلمته عهداً، وعدالته ميزاناً لا يميل”.
لقد آمن الفقيد بأن التنمية لا يمكن أن تنبت في تربة ملوثة بدم الخصومات، لذا جعل من “السلم الاجتماعي” حجر الزاوية في إدارته. كان يرى في القبيلة مكوناً إيجابياً إذا ما وُظفت قيمها في خدمة القانون، واستطاع بعبقريته الفذة أن يجعل من الوجاهات الاجتماعية أدوات لبناء الدولة لا لتقويضها. الشهادات المنشورة عنه تؤكد أنه كان يرفض الانصياع للضغوط الضيقة، منحازاً دوماً للمظلوم، ومقرباً للمخلصين، مما جعل منه “قاضياً غير متوج” في فض النزاعات الكبرى التي عجزت عنها أجهزة الدولة التقليدية في ذلك الحين.
خمس سنوات انقضت، واليمن يفتقد اليوم ذلك الطراز من القادة الذين يمتلكون القدرة على لّم الشتات. إن إرث الفريق يحيى مصلح في السلم الاجتماعي يظل درساً بليغاً في كيفية إدارة المجتمعات المعقدة بروح المسؤولية الوطنية. لقد رحل الرجل الذي كان ينام والناس آمنون بفضل يقظته وعدالته، تاركاً خلفه سيرة بيضاء تؤكد أن القائد الحقيقي هو من يبني في قلوب الناس قصوراً من المحبة والثقة، لا من يكتفي ببناء الأسوار حول منصبه.